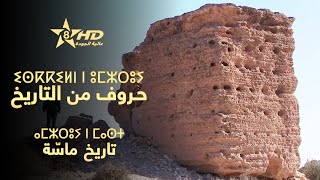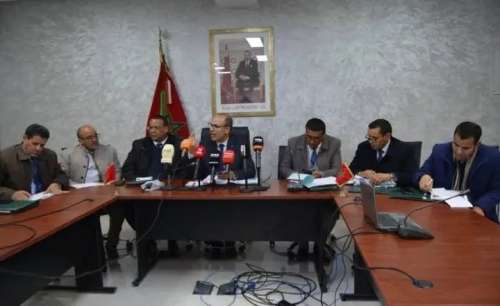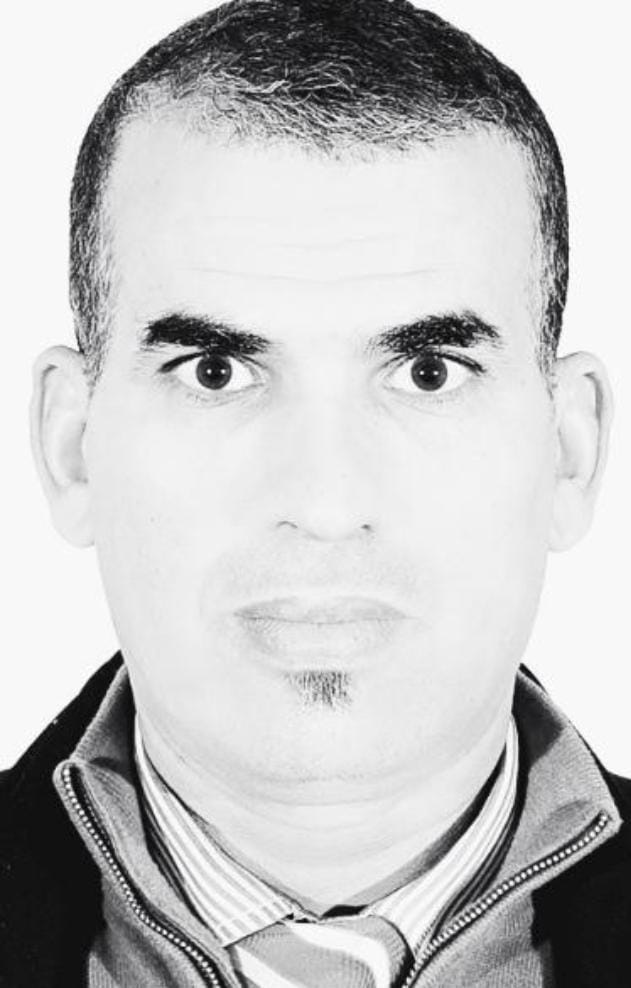- بقلم: أستاذ يحاول ألا يتشظَّى (سليمان محمود) جديدأنفو
في بداية السنة الجديدة 2025م، اكتسح "الشكلاط" "التراندر التربوي"، فصار أبرز أحداث المدرسة المغربية، في عالم السوشيال ميديا، واجتاح المدارس المغربية، كما تجتاح الجُرذان مخزن قمح قديم. التلاميذُ، في كل مدرسة، يكررون مشاهد منقولةً، لا إبداع فيها، فيوزِّعون قِطعَ الحلوى على أساتذتهم وأستاذاتهم. يفاجئونهم، حين يقومون واحداً تلو الواحدة، يملأون مكتب الأستاذ بتلك الحلويات، وإنْ أبدعوا، فأبداعهم لا يتجاوز إحضار قالب سكر ضمن الحلويات التي يغطون بها يديه المفتوحتيْن في فرحة طفوليةٍ، وكأنهم يخبرونه بأنه "تْقْوَالْبَا"، بتصوير فيديوهات ستُشْعِل بها سطوريات التلاميذ، في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحرصون على إظهار فرحتهم بالحدث، وتفاعلهم العاطفي معه، لينال إعجاب المتابعين. ريلزات مشحونة بهاشتاغات عديدة؛ أحدها: "#حب_الأستاذ"، يُحصد فيه حب زائف، ولعب بالأَلْغُوريثْمِ الآثِم تجسساً، لا غير.
لكن ما بدأ بشكلاطة، انتهى بضربة قاتلة، انطلق عنفها من داخل أسوار المدرسة، وساحتها الكئيبة. هكذا، وفي أشهر قليلة، مررنا من "تراند التحلية" إلى "تراند التصفية"، دون المرور بمقاعد الفهم.
لقد أثبت تراند الشكلاط أنه نكتة أشبه بتمرينٍ ناعمٍ لزمن سيشتاق فيه الأستاذ للتحلية، لأن القادم سيكون أكثر مرارة. وهو ما حصل، حين أطلّ علينا "تراندٌ" جديدٌ، جوهرُه العنف الذي أفضت حالات منه إلى الموت. ولا تهم الأسباب في هءه المواقف، إذ لا شيء يمكن له تبرير العنف، أيا كان نوعُه في هذا الفضاء المقدس؛ فضاءِ بناء العقول، وتهذيبِ الأذوق، وإزهار بذور القيمِ المفروضِ أن تزرعها الأسرةُ، في بناتها وأبنائها.
لم يعد العنف سلوكاً منحرفاً، وإنما صار موضةً تربويةً، ترسمها رِيلزاتٌ انفعاليةٌ قصيرة على تيك توك، أو الأنستغرام، وتُعاد مشاركتها بكثير من الضحك، وقليل من الحياء، بتعليقات ترى أن الأستاذ يستحق أكثر مما ناله. حتى ولو مات، فميتة واحدة لا تكفي، ليشفى الغليل.
هكذا، تبدو المدرسةُ المغربيةُ مثل خشبة مسرح تراجيدي عبثي، يعلو فيها صوت الصراخ على صوت القصيدة، وتتحول فيها السبورة إلى درع وقاية، لا أداة معرفة؛ فتيقَّن الأستاذُ اليومَ أنه ليس موظفاً مكافحاً، وإنما قد يكون هدفاً متحركاً، وعليه ألا يكتفي بإجادة الشرح، وأن يتجاوز ذلك لتعلم المراوغة، كما ينبغي عليه تعلُّم مسح دموع الأسف والأسى، كما يمسح السبورة، وإتقان قواعد الاشتباك، إتقانَه لقواعد التدريس.
ولكن، من المسؤول يا ترى؟ أهو التلميذ الذي نَبت على أنقاض التفكك؟ أم الأسرة التي تعيش في هزائمها اليومية مع غلاء الأسعار، وتراكم فواتير الكهرباء والماء، وطَرَقات صاحب المنزل لتحصيل سومة الكراء؟ أم البرامج التي تعتبر الشعر الجاهلي أكثر إغراء من كرة القدم؟ أم الأستاذُ نفسُه، حين فقد سلاحَه الرمزي وسط فوضى القيم؟
إن من واجبنا الاعتراف بكلمة الحق؛ وهي أنَّ الجميع –بلا استثناء– شركاءُ في هذا المشهد التراجيدي؛ بدءاً بالأسرة، مرورا بالشارع/المجتمع، والإعلام، ومنابر المساجد، والمدرسة، وصولاً إلى ثلاجةِ الوزارة التي تُحفظ فيه جثامين المقررات الميتة منذ عقودٍ، وتكتب المذكرات كمن يكتُب وصية قديمة.
والمفارقة العجيبة أننا نُطالب التلميذ المغربي اليوم أن يُحلل قصيدة لابن زيدون، بينما رأسه يعجّ بمقاطع "التراندات"، وخزعبلات الباحثين عن المتابعين كقطعان عاكفة على معابد محتوياتهم، وخيالُه مشغول بلعبة الفري فاير، والبابجي. نطلب منه أن يعرب جملة فيها مروءة وإنسانيةٌ، بينما لا يجد وجبة كاملة في البيت، ونُطالبه أن يفهم مبرهنة طاليس، وهو بالكاد يفك حروف اسمه، ويكتبه بدون أخطاء. نرسم له مثلثاً في سبورة متشققة، ونطلب منه حساب زواياه، في عالم لا زاوية له يأوي إليها. نسأله عن المتطابقات الهامة، بينما لا أحد منهم تطابق مع واقعه منذ دخوله المدرسة.
ما زلنا نلقِّنه "Le chat est sur le toit"، في الوقت الذي يسكن فيه التلميذ في منزل هش، لا يملك سطحاً يصعد إليه. أما القطط عندنا، فلا تصعد إلا فوق حاويات الأزبال، لعلها تجد قطع خبز جافة، تبقيها على قيد الأمل.
إنه يكره الفرنسية، لأنه نشأ في مجتمع يكرهها؛ فمِخياله يتمثلها بوجه كولونيالي بارد وبَشِع، وفُرِضتْ على بيئة تشعر أنها غريبة عنها، وكلما نطق "passé composé"، شعر أنه ماضٍ مؤلم، مؤلَّف من هزائم، لا أزمنة.
نسأله عن رأيه في أطروحة أفلاطون حول العالم المحسوس، وهو لم ينجح بعد في الإحساس بنفسه، ونُغرقه في ميتافيزيقا لم يلمس منها سوى متاهة، ونحاول إقناعَه بأن سقراط مات من أجل الحقيقة، بينما يرى أستاذه يحتضر في صمت من أجل التقاعد، ويتابع ذلك في المجموعات الفايسبوكية المفضوحة التي لا يتوقف فيها الأساتذة عن الشكوى والبكائيات.
وهنا، مربط الطباشير؛ فالمنظومة ترغمنا على تدريس مناهج مكتظة، بلغة تقليدية، وفق مذكرات وزارية صارمة، داخل فصول باردة كالعزلة. نُدرّس كأننا نعلّم نخبة أثينية، بينما الواقع يكشف تلاميذَ بلا دافع، ولا دعم، ولا أفق؛ فيبحثون عن ملاذ في هواتفهم الذكية، والتراندات السخيفة، ولو كان ملاذ من وهم.
أما المفتشون، فإنهم لا يسكنون بيننا، ولذلك فهم يرون الواجهة فقط؛ يرون قسماً مرتباً، وتلاميذ صامتين منضبطين، وأستاذاً يُبدِع في بناء الوضعية الإدماجية، ويتفنن في تقديم الدروس النموذجية. لا أحد يسأل كم مرة بكى هذا الأستاذ، وكم مرة فكّر في الاستقالة، وعن لحظات إحساسه بدخول معركة بلا ذخيرة، كلما ولج الفصلَ، وهو يُدرك بأنه سيواجه جيشاً من اللامبالاة، ويحارب بإحساسه ذاك يومه الطباشيري الطويل.
لكن، رغم هذا كله، هناك دوماً بذوراً تنبت بصمت وهدوء، خلف الجدران المتشققة. تلميذ تشتعل عيناه ببريق سؤال، وفتاة تعود لتقرأ الشعر بعد الحصة، ونظراتُ اعتراف غير منطوقة تقول: "شكراً أستاذ، رغم كل شيء". هؤلاء هم الأمل. هم مدد الأستاذ، وطاقته التي تقويه ليواصل، ويتذكر الرسالة: "التعليم ليس مهنة... إنه مقاومة".
|
|